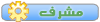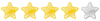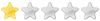Obada Arwany,
جزاكَ الله خيراً

شكراً على المقال .. قرأت فيه معلومات جديدة و أودّ التعقيب على بعض النقاط
اقتباس:
وتستخدم الترجمة الشفوية الآن، على نحو واسع، ليس فقط في المؤتمرات الدولية ولكن أيضا في الراديو وبرامج التلفزيون، ومختلف المحاضرات والدروس، والزيارات الحكومية الرسمية، التي تجعل مصطلح ' ترجمة شفوية للمؤتمر ' خطأ في التسمية . ما يميز ترجمة شفوية للمؤتمر الآن عن الأشكال الأخرى من الترجمة هو أنماطها (التتابعية والفورية)، ومستواها عالي الأداء.
صحيح .. أضحت الترجمة من أهم عوامل التواصل بين الشعوب و خصوصاً في أيامنا هذه التي أصبح يها العالم قرية صغيرة .. فلا غنى عن الترجمة ..
في الحقيقة لا أعلم إن فهمت حقا المقصود هنا بـ "الترجمة الشفوية للمؤتمر" ربما هو اصطلاح أجنبي و تطور مفهومه حسب ما ذُكر بالنص
اقتباس:
في الترجمة الشفوية التتابعية ، يستمع المترجم إلى قطعة من خطاب لبِضع دقائق أونحوها، ويدون الملاحظات، وبعد ذلك يقدم القطعة كاملة من الخطاب في لغة الهدف؛ ثم يستأنف المتكلم خطابه لبضع دقائق، ثم يقدم المترجم القطعة التالية، وتستمر العملية حتى نهاية الخطاب. في أغلب الأحيان تكون الترجمة الشفوية ' جملة جملة ' في ترجمة الارتباط أو التواصل المتبادل ، والترجمة الشفوية للجماعة لم يعدها المترجمون الشفويون للمؤتمر '
كمتتابعة حقيقية '.
طبعاً تختلف الترجمة التتابعية عن الفورية من حيث الجهد المبذول و السرعة المطلوبة في الأداء فهي أسهل من الفورية
اقتباس:
في الترجمة الفورية ، يجلس المترجم الشفوي الفوري في كشك ترجمة، يستمع إلى المتكلم من خلال سماعة ويترجم إلى مكبر صوت، بينما يستمع المندوبون في غرفة المؤتمر إلى نسخة لغة الهدف من خلال السماعات التي يستخدمونها.
اقتباس:
هي شكل من أشكال الترجمة (chuchotage) الترجمة المهموسة أو شاشوتيج الفورية التي لا يجلس فيها المترجم في كشك، ولكن يجلس في قاعة المؤتمر، بجانب المندوب الذي يحتاج إلى الترجمة، ويهمس في أذن المندوب بنسخة الخطاب بلغة الهدف.لا يقتصر أي نمط من أنماط الترجمة الشفوية هذه على مكان المؤتمر . فالترجمة
الفورية ، على سبيل المثال، استعملت في قاعات محاكمات كبيرة متعددة اللغات، و قد تستعمل الترجمة المهموسة في اجتماعات العمل.
هذا نوع جديد أقرأ عنه .. على مايبدو هذه الترجمة تستخدم على نطاق ضيق و ليس على مستويات رسمية كبيرة
اقتباس:
اختلافات بين الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية بينما يشدد أكثر العلماءِ على أن الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية ينجزان الوظيفة نفسها أنجازا جوهريا، إلا أن الكثير - خصوصا المترجمون الشفويون - يعدون النوعين مختلفين جدا، حتى مِهنتيهما غير متوافقتين . أن هذا الزعمِ، بالإضافة إلى اختلافات شخصية مزعومة بين المترجمين التحريريين و المترجمين الشفويين (هيندرسن ١٩٨٧ )، لم توثق توثيقا واضحا في الأدب . على أية حال، فيما يتعلق بالترجمة الفعلية وممارسة الترجمة الشفوية، بعض الاختلافات بينهما ليست جدالية . وينشأ الاختلاف الأكثر وضوحاً من حقيقة أن المترجمين التحريريين يتعاملون مع اللغة المكتوبة ولديهم وقت كاف لتحسين عملِهم، بينما يتعامل المترجمون الشفويون مع لغة شفهية وليس لديهم الوقت الكافي لتنقية ناتجِهم
من المؤكد أن هناك اختلاف بين الترجمة الشفوية (بأنواعها المختلفة) و التحريرية .. و إضافة لما ذُكر فالترجمة التحريرية تبقى و تحيا حتى بعد فناء المترجم أما الترجمة الفورية فهي تؤدي وظيفة قلنقل وقتية و أقصد بوقتية أي أنها تكون مطلوبة في وقت معين لتوصيل رسالة معينة بين طرفين أو مجموعتين و تكون مهمة بفترة زمنية محدودة .. أما الترجمة التحريرية فتحفظ الأعمال المترجمة و أحيانا تخلدها عبر الأجيال.
اقتباس:
والنتائج المترتبة على ما سبق هي:
من الضروري أن يكون لدى المترجمون ألفة بقواعد اللغة المكتوبة أو يكونون كتابا مؤهلين في لغة الهدف؛ إذ يحتاج المترجم الشفوي لإ تقان ميزات اللغة الشفهية ويكون متكلما جيدا، وهذا يتضمن استعمال صوته بفعالية ويطور ' شخصيته عبرمكبرالصوت '. أي معرفة إضافية، على سبيل المثال، المعرفة الاصطلاحية أو العالمية، يمكن أن ·
تكتسب أثناء الترجمة المكتوبة، ولكن يجب أن تكون مكتسبة قبل الترجمة الشفوية..على المترجمين الشفويين أن يتخذوا قراراتهم أسرع من المترجمين التحريريين. ·أي مستوى تحليل للمهارات المطلوبة في الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية يجب أن ينتظرالتقدم في علم اللغة النفسي وعلم النفس الإدراكي . فعلى خلاف الترجمة، تتطلب الترجمة الشفوية انتباها ومشاركة ويشمل قيود الوقت المحددة. فالعديد من أخطاءِ الترجمة الفورية المتكررة قد تثبت انها نتيجة اما وصول قدرة معالجة المترجم الفوري إلى نقطة التشبع أو إدارة غير صحيحةِ لها (انظر ما يلي ). مناقشة تفصيلية للاختلافات والتشابهات بين الترجمة.(Gile التحريرية و الترجمة الشفوية وتطبيقاتهما للتدريب يمكن أن تجدها في جايل ( ١٩٩٥
ذُكرت هنا نقاط جميلة عن بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها المترجم الشفوي .. بشكل عام أستطيع أن أضيف أن المترجم الشفوي يجب أن يكون إنسان ذو شخصية متميزة و مثقفة بكل مافي الكلمة من معنى و يجب أن يكون سريع البديهة قوي الشخصية طلق اللسان .. بالإضافة للمهارات اللغوية و بذلك يكون مترجماً شفويا بحق و لا يمكن لأي إنسان عادي أن يصبح مترجماً شفوياً بهذه السهولة.
اقتباس:
بدأ بعض المترجمين الشفويين ومدرسو الترجمة في جنيف (هيربيرت (van Hoof 1962)Rrussels وروسيلز ،Ilg اليج 1959 ،Rozen 1952 ، روزن 1956 بالتفكير في مهنتهم والكتابة عنها، وكانت هذه الكتابات مبادرات وانطباعات شخصية مع أهداف تعليمية وعملية محترفة، ولكنهم لم يميزوا أغلب القضايا الأساسية التي ما زالت محل نقاش حتى اليوم . وكانت إطروحة ماجستير متعمقة هي الدراسة الأكاديمية الأولى عن الترجمة الشفوية،. نوقشت في جامعة لندن في ١٩٥٧ ،Paneth للباحثة ايفا بانيث أثناء الفترة التجريبية
نقرأ الكثير الكثير من المقالات حول الترجمة و بعض النظريات و لكن ربما إلى الآن لم يستطع أحد أن يتوصل إلى أسس علمية و عملية ثابتة يمكننا اتخاذها كقانون مثل أي علم آخر عن الترجمة .. فهي بحر واسع جدا و مقعد أيما تعقيد .. و لكن بالمقابل هناك خطوط عريضة أصبحنا على دراية كافية بها يمكن أن نصقل فيها طريقتنا بالترجمة و كما نقول دائماً الممارسة و الخبرة هي أفضل ما يمكن أن يطورنا.
اقتباس:
بعض علماء النفس وعلماء اللغة النفسي مثل مهتمين بالترجمة الشفوية، وتعهدوا (Gerver انظر 1976 ) Barik و ،Gerver ،Eisler عددا من الدراسات التجريبية عن وسمات نفسية ولغوية نفسية معينة للترجمة الفورية ودرسوا
التأثير على أداء المتغيرات مثل لغة المصدر، وسرعة الأداء، ومدى صوت الأذن (بمعنى آخر: الفترة الزمنية بين اللحظة التي تدرك فيها المعلومة واللحظة التي يعاد فيها صياغتها بلغة الهدف )، والضوضاء، والوقفات في أداء الخطاب، ... الخ . رفض الممارسون كلتا النظريتين ورفضوا نتائِج مثل هذه الدِراسات ايضاً.
ياإلهي وصلت الدراسات عن الترجمة لعلماء النفس!

و لكن فعلاً بعد التفكير أرى أنه أمر جيد و مؤكد أن هذا الأمر يدعم أداء المترجم الشفوي ..
اقتباس:
ركزت أكثر الدراسات على العمليات المركزية للترجمة الفورية . والسؤال الهام للمحققين الأوائل كان هل المترجمون الفوريون ترجموا فعلا بطريقة فورية؟ وهل استمعوا وترجموا في الوقت نفسه . أكد البعض أن هذه العملية نادرا ما تحدث ، وأن أغلب إنتاج خطاب المترجم الفوري تم خلال وقفات المتكلم

ربما لا نستطيع أن نقول ترجمة فورية 100% و لكن الفرق يكون أحياناً ثواني أو عند الوقفات القصيرة للمتكلم بين الكلمات .. بالإضافة لسرعة المتكلم أثناء الحديث .. أقرّ و أعترف أن عملية الترجمة الفورية عملية صعبة للغاية فعلى المترجم أن لايغفل عن المتكلم و لو حتى جزء من الثانية و إلا أضاع فكرة أو أكثر فعليه أن يكون صافي الذهن تماماً
اقتباس:
السؤال الهام الثاني متعلق بطبيعة النشاطات العقلية التي تحدث خلال الترجمة الفورية . فبينما وافق كل الباحثين على أن إنتاج الخطاب وتصوره جزء من العملية العقلية، لم يتم عمل الا القليل عن بعض النشاطات الأخرى المفترضة أو التي تحدث ، ولا يعرف الا القليل عن التشابهات والاختلافات بين إنتاج الخطاب وفهم الخطاب في الترجمة الشفوية مقابل السياقات وعلى وجه الخصوص ، theorie du sens الأخرى. بالنسبة لمناصري اقتراح نظرية المعنى من المجموعة ، لا يوجد مثل هذه الاختلافات.
اقتباس:
فإن المترجمين غالبا ما يبدأون صياغة جملهم بلغة الهدف قبل حصولهم على صورة كاملة للفكرة التي يريدون التعبير عنها. يؤيد البعض،الاستراتيجيات المضادة التي تتضمن اختيار Ilg ( على وجه الخصوص، الخ ( 1978 بدايات جمل "المحايدة" التي تسمح للمترجم بصياغة الجملة بسهولة أكبر نحو خاتمة المتكلم، متى تصل الخاتمة إلى نهايتها.
هنا أيضاً طبيعة اللغة الهدف و اللغة المصدر تؤثر في أداء المترجم كما نعلم أن الجملة في اللغة العربية غالباً فعلية و لكنها مرنة و لكن الجملة في اللغة الانكليزية دائما اسمية و تبدأ بالفاعل و قد يتأخر ذكر الفعل .. و هنا على المترجم أن يكون سريع البديهة و أن يتبع استراتيجيات معينة ليستطيع أن يوازن بين الفرق بين اللغتين.
اقتباس:
ويؤكد البعض الآخر بأن المترجمين عليهم أن يقاوموا التدخل اللغوي المستمر من اللغة المصدر، في بعض الأحيان بتجنب كلمات وتراكيب اللغة الهدف التي تتشابه إلى درجة كبيرة مع تلك المستخدمة في خطاب اللغة المصدر . فيما يتعلق بفهم الخطاب، أشار الكثير إلى أن معرفة المترجم بالموضوع والموقف أقل شأنا من المشاركين الآخرين . وعليه أن يحقق الفهم خلف المستوى المتوقع عامة من المستمعين وليس مطلعا (ملما) بالموضوع (جيل
١٩٨٩ ). اختلافات جوهرية أخرى اعتقدوا أنها موجودة ولكن لم يتم التحقق منها )Gile نظاميا. ومظهرهام أخر للنشاط العقلي للمترجم يركز على التعامل مع الصعوبة وذلك بالتغلب على الطرق والمناهج التي يختارها وينجزها عندما يواجه المترجمون الفهم والإنتاج ١٩٩٥ أ ، ١٩٩٥ ب). في حالة التتابعية، الجزء الهام ،١٩٩٤ ، وصعوبات أخرى (جيل ١٩٨٩
للنشاط العقلي للمترجم يتعلق بتدوين الملاحظات التي يختار المعلومات التي تدون، وحالة التدوين، بالإضافة إلى الطريقة التي تستعمل فيها الملاحظات خلال فترة إعادة الصياغة. قدرة المعالجة ونماذج "الجهد" خلال السنوات القليلة الماضية، أكد الباحثون على مقدرة المترجم على المعالجة ودورها في الترجمة. لقد عرف علماء النفس الادركيين لبعض الوقت أنه رغم ان بعض العمليات "آلية " بمعنى أنها تكتسب مقدرة المعالجة. البعض الآخر "غيرآلية" وتكتسب مقدرة المعالجة المتوفرة في الكمية المطلقة . في نماذج الجهد للترجمة الشفوية، التي طور كمحاولة لشرح الأخطاء كثيرة الحدوث والمتواترة والحذف الموجود في أداء الم بتدئين والمترجمين على حد سواء.،ويجادل جيل ( ١٩٨٩ ) أن المكونات الرئيسة لمعالجة الترجمة الفورية ليست آليه .
اقتباس:
تقسم الترجمة الفورية إلى ثلاث مجموعات من الجهد:
أ. جهد الاستماع والتحليل ، الذي يهدف إلى فهم خطاب اللغة المصدر.
ب. جهد الإنتاج الذي يهدف الى إنتاج خطاب اللغة الهدف.
ج. جهد الذاكرة قصيرة المدة، التي تعا لج المعلومات بين الفهم والإنتاج في اللغةالهدف.
و هذا كله يجب أن يُنجز خلال ثواني
اقتباس:
فيما يتعلق بالترجمة المتتالية، هذا منقسم إلى مرحله استماع، أثناءها يستمع المترجم إلى المتكلم ويأخذ الملاحظات، ويعيد صياغتها، وخلالها يعيد المترجم صياغة الخطاب باللغةالهدف.. أثناء المرحلة المستمعة، الجهود هما جهد الاستماع وجهد التحليل، وجهد إنتاج الملاحظة، وجهد الذاكرة القصيرة الأمد لإدارة المعلومات بين الوقت الذي يستقبل والوقت يأخذ وقت استراحة . أثناء مرحلة إعادة صياغة، هناك جهد قراءة ملاحظة ، وجهد ذاكرة طويله المدى، وجهد تذكير الخطاب، وجهد إنتاج الخطاب . يناقش جايل انه فيما يتعلق بالمترجمين المؤهلين فقط المرحلة الأولى حرجة، حيث أن المرحلة الثانية لم يتخطاها المتكّلم، ولم تتضمن كثيراً من الانتباه المشترك.
اقتباس:
إن مفهوم القدرة على المعالجة مربوط أيضا بنوع إجادة اللغات العاملة المطلوبة للمترجمين. بسبب قيود الوقت وقدرة المعالجة المحدودة، يجب على المترجم الشفوي ليس فقط أن يعرف الكلمات والقواعد اللغوية للغات العاملة، ولكن أيضا يجب أن يكون استعماله النشيط في الاستيعاب أوالإنتاج سريعا ويوافق قدرةِ المعالجة الصغيرةِ؛ بكلمة أخرى، معرفة المترجم اللغوية يجب أن تكون متوفرة جدا. هذا المتطلب حاسم في المترجمين الشفويين بالمقارنة بالمترجمون، الذين ليس من الضر وري أن يشتركون في الانتباه او يكرسون دقائق، أو ساعات أو أكثر في فهم أجزاء النص أواسترجاع الكلمات أوالقواعد اللغوية للاستعمال فينص هدفِهم.
اقتباس:
مفهوم 'القدرة على المعالجة ' يمكن أن يلقي الضوء على القضية الأكثر نقاشا وهي رغبة العمل من اللغة ( أ ) إلى اللغة (ب) أو بالعكس . يدعي العديد من المترجمين الأوروبيين الغربيِين بأن اللغة الوحيدة المتقنة بدرجة كافية لإنتاج الفاظ مقبولة للغة الهدف هي اللغة (أ)، وذلك يجب على المترجمين أن يعملوا على لغتهم (أ) . من ناحية اخرى،
يقترح العديد من المترجمين الشفويين من الكتلة الشرقية السابقة ، العكس، بمعنى أن المترجم يجب أن يعمل من لغة (أ)، لأن هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها بشكل جيد للرد بسرعة . سؤال هل و متى ينجز المترجمون المستوى المطلوب للقدرة في لغاتهم (أ) و (ب) ليس سؤالا ً سهل الحل، لانه ليس هناك أدوات دقيقة وموثوقة لقياس مثل هذه القدرة حتى الآن

.. نقطة مهمة و محط تساؤل .. بتصوري أنّ الترجمة الشفوية من اللغة الأجنبية إلى اللغة الأم تعطي نتائج أفضل و خصوصاً عندما يكون الجمهور يتكلم اللغة الأم للمترجم التي يترجم إليها .. فيتلقى الجمهور الكلام أوضح
اقتباس:
قد يكون الإنتاج أكثر او أقل صعوبة بالاعتماد على القوة المعجمية والمرونة النحوية للغة الهدف . السهولة و العول في الاستقبال قد يتأّثران اللاسهاب القواعدي و المعجمي الداخلي (كلمات قصيرة أو طويلة، ومؤشرات قواعدية). في لغات مثل اليابانية والصينية ، قد تزيد المجانسة اللفظية من كمية قدرة المعالجة و / أو الوقت المطلوب لحل الشفر ة. الاختلافات النحوية بين لغات المصدر والهدف قد تزيد مستوى الصعوبة أيضا، بشكل ر ئيسي بسبب الخزن الإلزامي لكمية أكبر من المعلومات بين الفهم والإنتاج : المعلومات المطلوبة للاِستمرار بصياغة الجمله في اللغة الهدف قد تعطى فقط في جملة اللغة المصدر بعد المعلومات الأخرى، التي سيعاد صياغتها نموذجيا في المرحلة التالية في اللغة الهدف . هذه الفرضيات، على أيةحال، تتوقف على اختبار تجريبي خلال دراسات لغويِة ولغوية نفسية في المستقبل.
جميل .. هذا يعني أن أحد الصعوبات التي تواجه المترجم الشفوي هي طبيعة اللغة المصدر و اللغة الهدف .. و هنا عندي تساؤل: هل فعلاً طبيعة اللغة المصدر و اللغة الهدف تشكل أحد الصعوبات أمام المترجم الشفوي لغوياً بالإضافة لعامل الوقت, أم أنّ تلك الصعوبات لا تشكّل عائقاً أمام كفاءة المترجم الضليع بحق باللغتين مهما كانتا؟ أم الاثنين معا و لكن بنسب متفاوتة؟
kamelhammoud,
شكراً لمداخلتك القيّمة

اقتباس:
لم يتناول كاتب المقال الأصلي و القائمون بالدراسات الجهد الذي يبذله المترجم الفوري في المؤتمرات عند:
* استخدام المتحدث للكثير من الألفاظ العامية وغير الشائعة في اللغة الأصل.
* استشهاد المتحدث بأمثال غير متداولة أيضا.
* "وهنا الطامة الكبرى" أن يكون المتحدث يلثغ بحرفٍ أو أكثر، طبعا لن يعي المترجم الفوري ذلك إلا بعد أن يكون قد قطع شوطاً كبيراً من التخبط في تعابير اللغة المترجم إليها أو لغة الهدف. " تخيل أنك تجلس في تلك الغرفة الزجاجية المقابلة للمتحدث من خلف رؤوس جميع الحضور وتتابع وتدقق حركة شفتيه عن بعد لتتأكد هل نطق كلمته بشكل صحيح أم أنك أخفقت في سماعه!
* عدم استجابة المتحدث لكل توسلات المترجم واستغاثاته بأن يرفع صوته ولو قليلاً.
فعلاً .. لقد ذكرت نقاط مهمة تندرج في الإطار العملي في الترجمة الشفوية .. و يجب أن تُراعى الأمور التقنية أيضاً و التأكد من أن مكبر الصوت و جميع التوصيلات تعمل و إلا ستذهب جهود المترجم أدراج الرياح إذا ما ضُبطت الأمور التقنية
و فيما يخص النقطة الثالثة فقد ناقشنا منذ زمن طرائف المترجمين و كانت واحد من تلك الطرائف حول ما تفضلت به..
"أذكر أني دعيتُ لترجمة كلمة ألقتها ضيفة من اسكتلندة حلّت في إحدى الأمسيات الأدبية. وكانت تلثغ فتلفظ السين ثاءً. فبذلتُ قصارى جهدي لالتقاط كلماتها بمفهومها الصحيح، لكنها حين قالت: Sorry, I mixed things حسبتُها تقول: Sorry, I missed things ، ولتبديد الشك رجوتها إعادة الجملة، فأعادتها، ولم أميّز ما قالت. فسألتها: Missed or Mixed? قالت: I mean mith.. th..ted مشدّدة على الثاء... فلم أتأكّد مما سمعت، وخجلتُ من تكرار السؤال، فتوجهتُ إلى الجمهور وقلت: إما أنها أسقطَت أشياءً أو خلطتها... لكُم أن تختاروا! فضحك المستمعون، وأدركَتْ هي ما يجري فتناولت ورقة كتبت فيها بخط عريض: MIXED ودفعتها إليَّ."