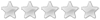دراسة الرُقم والكتابات المسمارية التي اكتشفت في موقع أوغاريت «رأس الشمرا» على الساحل السوري، قدمت لنا معلومات كثيرة طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية التي كانت سائدة في الألف الثاني قبل الميلاد في الساحل السوري بخاصة وبلاد كنعان بشكل عام..
لقد أعطانا أرشيف النصوص الغني في أوغاريت، فكرة واضحة عن عالم الآلهة وأساطير المدينة في الألف الثاني قبل الميلاد، فعلى رأس الآلهة يقف إله السماء «إيل» (أبو الآلهة وملكها)، وبينما يظهر «إيل» في الأساطير الأوغاريتية سلبيًا، نرى إبنه «بعل» إله الخصب والمطر، النشيط الفعّال، يتصدر مصدر الأحداث في أكثر الأحيان، ويرتبط بالناس وعاداتهم وحياتهم، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا «بعل» دون غيره من الشخصيات تم التركيز عليها في الأساطير الأوغاريتية؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه..
لماذا الإله بعل؟
بالرغم من شهرة سكان أوغاريت في مجال الملاحة البحرية، وفي التجارة، فإن ديانتهم وطقوس عبادتهم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأرض، وتدل الدراسات الأثرية وعمليات التنقيب التي تمت في الموقع على أن السكان استقروا وعملوا في الزراعة، وكانت آلهتهم تهتم بالفلاحة وإنتاج الحبوب وإنضاج الثمار، ونجد أن آلهة أوغاريت كانت غير متعالية وليست غبية، فحتى الإله الأكبر «إيل» كان يقطن عند مصب الأنهار، والإله «بعل» يقيم في جبل صفون ( صفن) إلى الشمال من مدينة أوغاريت، وهذا يعني أنهم أرباب يسكنون الأرض وبقرب البشر.. والديانة الأوغاريتية كانت ديانة خصب وتأليه قوى وعناصر الطبيعة أو ضبطها عن طريق إله يتسلط عليها ليتم تنظيم دورة الفصول و«وإن كل ما في الطبيعة حي» والصراع بين عناصر الخصب وعناصر القحط، دائم وموسمي، مما يدل على فهم سكان الساحل السوري لطبيعة التغيّر والتبدل، وهذا أمر جعل منهم أصحاب أول نظرة مادية جدلية في التاريخ، والصراع الذي يقوم بين الإله «بعل» إله الخصب والمطر والعطاء، والإله «موت» إله القحط والجفاف والمجاعة, ما هو إلا صراع بين عناصر الخير والشر، وتعبير عن دورة الطبيعة، فعندما تكون الغلبة للإله «موت» يحتم على الإله «بعل» النزول إلى الجحيم مثله في ذلك مثل أشباهه: (دوموزي- تموز- أدونيس..) يحل القحط لانقطاع المطر في غيابه، وتهدد المجاعة الناس ويخيّم على الأرض شبح الكارثة، وتبدو نهاية العالم على وشك الحدوث، غير أن «البعل» لا يلبث أن يبعث من الموت، وتلعب الربّة العذراء «عنّات» دورًا مهمًا في هذا البعث، ويعود إليها فضل مصرع الإله «موت» وتحرير «بعل» وهي تماثل في ذلك «إنانا» السومرية، «وعشتار» البابلية.. وبعودة الإله «بعل» إلى الحياة ينهمر المطر، وتعود القوى الإخصابية إلى النشاط وتتجدد دورة الطبيعة، ويحتفل بجلوس «بعل» على عرشه في مرتفعات جبل «صفن=صفون» وليس هذا حفظًا للخصب فحسب بل ارتقاء إلى الرغد المادي والروحي، حسب تعبير الباحث الأستاذ فايز المقدسي.
طقوس مسرحية
يؤكد الباحث والمؤرخ الشهير «فيليب حتي» في دراسته عن سورية، أن أهل سورية في الألف الثاني قبل الميلاد كانوا يعبّرون عن فرحتهم بعودة «بعل» بطقوس مسرحية جميلة، وهذا الطقس يسبق معرفة اليونان بفن المسرح بعدة قرون، ويؤكد الباحث «كاستر» هذا الرأي مضيفًا أن الممثلين الذين كانوا يقومون بالأدوار الطقسية كانوا يغطّون وجوههم بالأقنعة التي تمثل شخصيات الأرباب والآلهة، أبطال الملحمة الأوغاريتية.. وفي الملاحم والقصائد الأوغاريتية نجد أسلوب التكرار السائد في صلب النصوص، وعلى نحو مسرحي يشير إلى ضرورة القراءة المرتفعة الصوت الموجهة إلى الجمهور، وقد وجدت في بعض الألواح الكتابية جمل اعتراضية أتت بين سطرين كتعليمات إلى القارئ أو الممثل لرفع صوته أو خفضه في مقاطع معينة من النص.
ويستنتج من ذلك أن قراءة النص المقدس كانت احتفالية طقسية، تقام بمشاركة الجمهور، والهدف منها إعادة إحياء مآثر «بعل» وأثرها في حياة البشر.
ومن خلال الإطلاع على ترجمات بالنصوص الكتابية الأوغاريتية نجد أن الإله «بعل» كان يلعب دورًا حيويًا وأساسيًا في حياة البشر في الساحل السوري، وكان أكثر الآلهة شعبية، ولفظ «بعل» يعني السيد، وهو لقب الإله وليس اسمه، فهو سيد الأرض، وسيد الندى ويقيم في جبل صفون (صفن=جبل التأمل والتفكير) إلى الشمال من أوغاريت. أما اسمه الشخصي فهو «حدد» أي الواحد، وسماه الآراميون «آدون» أي السيد، وهي ترجمة آرامية لكلمة بعل الكنعانية, والكبير من الملوك في سورية الآرامية حملوا اسمه مثل: كبار حدد أي «ابن حدد» ملك دمشق وعزر حدد أي ملك صوبا في منطقة البقاع، وقد استعار الإغريق هذا الإله من سورية، وأطلقوا عليه اسم «أدونيس» وهذا الاسم كما هو واضح مأخوذ من اسم «آدوني» الآرامي، ويعني بعد إلحاق ياء النسبة «سيدي» أو «ربي»، وقد أشار العالم بتينو موسكاتي إلى ذلك إن الأسطورة في قالبها الإغريقي تنطبق تمامًا على أسطورة دوموزي- تموز البابلي الآشوري، وتماثل أيضًا أسطورة بعل في نصوص مدينة أوغاريت، وكان للإله «بعل» اسم محلي آخر هو «النعمان» وهذه مفردة كنعانية من الجذر «نعم» وتعني «الجميل» وبقيت إلى اليوم في «شقائق النعمان» ذات اللون الأحمر الذي يرمز إلى دماء الإله «بعل».
ملحمة الإله بعل
تقديرًا من سكان أوغاريت للإله «بعل» كرسوا له هيكلهم العظيم، كما كتبوا له ملحمة سطروها على الألواح الفخارية, ويبدو فيها شابًا وسيمًا شجاعًا يحب النظام ويكره الفوضى، يعمل للحياة ويكره الموت، ونراه في الرسوم والمنحوتات يحمل بيد (عصا) ترمز إلى الخضرة، وبيد (صاعقة) ترمز إلى أنه رب البرق والرعد وبالتالي المطر، وما زال سكان الساحل السوري بشكل خاص وسورية الطبيعية بشكل عام يطلقون اسم «أرض بعليّة» وخضروات وفاكهة «بعليّة» على ما يروى من ماء السماء بدون سقاية.
من ألقاب الإله «بعل» راكب السحب والغيوم، صوته الرعد، بهاؤه البرق، عندما يتكلم تزلزل الأرض والجبال ترتجف، وإذا احتجب (كما حدث له عند اختفائه في قلب الأرض) انحبس المطر، وجفت السواقي ويبس العشب وذبل الزهر، واختفى الحب، وانقطع التناسل والنسل... بناته «فدريّة» بنت الرعد، و«طليّة» بنت الندى، و«أرضيّة» روح التربة وخصبها، وأخته «عنّاة» التي كانت تساعده في العودة من الجحيم.
خصوم البعل
أما خصومه ومنافسوه، فهم: الإله «يم» إله البحر وإله المياه المتمردة الطاغية المخربة، والإله «موت» إله الموت والفساد والجفاف، وكان صراع «بعل» ضد اليم صراعًا كونيًا، غايته ترسيخ النظام، بينما كان صراعه ضد الإله «موت» صراعًا فصليًا، الغاية منه رتابة الفصول وتنظيم المطر ليسقط في أوانه ( المبكر في الخريف، والمتأخر في نيسان) وكل هذا لخير الإنسان.
ويلاحظ أن لقب «الأمير بعل» كان يرافقه خلال اشتراكه في الملاحم القتالية، أما لقبه الثاني( الأمير، سيد الأرض) فكان يطلق عليه خلال الحديث عن موته وبعثه وبالرغم من أن لقب الثور لا يلازم «بعل» في نصوص أوغاريت، إلا أنه يقوم بمعاشرة البقرة وينجب منها مخلوقات على شكل العجول، والمقصود بهذه العملية هو الإخصاب وديمومة الحياة، وبخاصة عندما يختفي«بعل» من الأرض، ويحتمل أن لا يتمكن من العودة إليها، ولا يشمل الخصب الحيوان فقط، بل الإنسان والنبات أيضًا، وتعد عملية الإخصاب هبة الإله بعل إلى الكائنات الحية، وفي الأصل لم يكن الثور لقبًا أو رمزًا له، وإنما انتزاعه من أبيه الإله «إيل» عندما احتل مكانه على العرش.
قصر الإله بعل
لقد كان بناء قصر للإله «بعل» محور الحديث الأساسي في الأساطير الأوغاريتية المتعلقة بالإله بعل، فبعد أن ينتصر على الإله «يم» يرسل الإله «عنّاة» إلى الإله «إيل» لأخذ الموافقة على بناء قصر مناسب له، إلا أن أسلوب «عنّاة» في الحديث أمام «إيل» كان فجّاً وسمجًا فيخيب مسعاها، فيلجأ الاثنان إلى الإله «عشيرة» التي تنجح بإقناع أبي الآلهة بأسلوب ناعم رقيق، على الموافقة ببناء القصر، ويقوم إله الحرف والفنون «كوثار» وزميله «حاسيس» بتنفيذ ذلك، فتحضر مواد البناء من لبنان، وبعد الانتهاء توقد النار في القصر لمدة سبعة أيام دون أن يخبو وميضها، وبعد ذلك تطلى جدران القصر بالذهب والفضة، ثم يدعو «بعل» الأصدقاء من الإلهة لتدشين البناء الرائع الذي كشفت آثاره بقايا أوغاريت، ويعتقد العالم الأثري «كلود شيفر» أنه كان للقصر نافذة على السطح تسمح بهطول الأمطار فوق تمثال الإله «بعل» الذي عثر عليه وفيه بقايا الأخاديد التي سببتها مياه الأمطار بفعل السقاية المقدسة.
دورة الحياة
عالم الآثار الأستاذ «غوردون» يؤكد أن نصوص أوغاريت تزودّنا بمؤشرات تدل على وجود دورة حياة كاملة للإله بعل تستغرق سبع سنوات، إلا أن هذه المدة التي استغرقتها الإله «عنّاة» عندما توجهت بالرجاء إلى الإله «موت» للإبقاء على حياة الإله بعل كانت بضعة أشهر، وقبل أن تقتله هي وتقضي عليه، كما أن النصوص لا تفصح عن المدة التي قضاها الإله «موت» في العالم السفلي قبل أن يعود إلى الحياة ثانية، إلا أنها تذكر أنه بقي سبع سنوات عاطلاً عن العمل لا يخوض خلالها أية معركة، وبعد مضي سبع سنوات من تمزيق جسده بيد «عناة» نراه يعود ثانية يستفز بعل ويرسل له رسائل تهديد، ويبدأ الصراع مجددًا بين الإلهين، ويحسم الصراع دائمًا لصالح الإله «بعل»...
ومنذ ذلك الحين تصبح عادة أن يظهر كل منهما لمدة سبع سنوات، وعدم التوافق في تحديد عدد السنين لا يعني تناقضًا بقدر ما يعني المبالغة الشعرية في النصوص، في وصف الحالة المزرية التي وصلت إليها البلاد خلال غياب الإله بعل، ومن المعروف أن موضوع السنين السبع العجاف من المواضيع المحببة في قصص الشعوب القديمة.
رسالة الإله بعل في الأساطير الأوغاريتية، وضّحها نص مسماري مكتوب يقول:
رسالة العظيم بعل
كلمة البطل الجبار
أبعد الحرب عن الأرض
واقضِ على المنازعات في البلاد
ودع السلام يتسلسل إلى باطن الأرض
ودع الصداقة تنمو بين الحقول.
د. علي القيـّم
_________________
وقال لي أقعد في ثقب الأبرة ولا تبرح واذا دخل الخيط فلا تمسكه واذا خرج فلا تمده وافرح فأني لا أحب إلا الفرحان